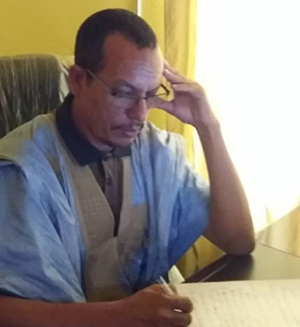تستعد الدولة الموريتانية لإطلاق حوار سياسي استجابة لطلب بعض أحزاب معارضة النظام السابق، لكن هناك بعض الأسئلة الجوهرية التي لا ينبغي أن نذهب إلى الحوار ما لم نجد لها أجوبة مقنعة تستند إلى حاجة وطنية ملحة يقتضيها الحوار المزمع تنظيمه: لماذا نتحاور؟ هل نحن في أزمة؟ هل المطالبون بالحوار يمتلكون وصاية على الشعب والوطن أكثر من نظام منتخب ديمقراطيا ويتمتع بالمصداقية داخليا وخارجيا؟ هل النظام عاجز عن تشخيص مشاكل الوطن؟ أم أن هدف الحوار هو ترضية بعض الساسة الساعين إلى تحقيق أجندات خاصة بلبوس وطني؟
تلكم جملة من الأسئلة من ضمن أخرى يضيق المقام عن طرحها، تحتاج إلى أجوبة مقنعة قبل الدخول في الحوار الجاري تحضيره، ومع أني لست معنيا بالإجابة عليها، نظرا لقناعتي بعدم جدوائية الحوار، إلا أني سأحاول الرد عليها حسب فهمي المتواضع حتى نعطي للقارئ الكريم صورة مكتملة بدل التشويش على فهمه وتشتيت فكره.
الدولة الموريتانية لا تعيش أزمة سياسية أو اجتماعية تبرر ذهاب أطرافها إلى طاولة الحوار لإيجاد حل لها، فعلى العكس من ذلك فهي تعيش هدنة وانسجام سياسي منذ وصول الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة، وعليه لا يمكن فهم الحوار أو تفهمه خارج صياغ هدنة مدفوعة الثمن من طرف النظام، وأن الحوار أو التشاور من ضمن ما حصل عليه التفاهم بين النظام والمعارضة المستقيلة، وبالتالي يكون النظام ملزما بتقديم عربون صمت المعارضة طيلة سنتين من ناحية، وإضفاء شرعية التشاور على نتائج الحوار أو التشاور من ناحية أخرى.
المشاكل التي يعاني منها البلد معروفة لا تحتاج التوضيح ولا التوصية من معارضة نشطة فأحرى معارضة مستقيلة منذ إعلان الرئيس السابق نيته عدم الترشح لمأمورية ثالثة، مشاكل موريتانيا يعرفها الرئيس و وزراؤه أحسن من المعارضة، ويمتلكون القوة التنفيذية لحلها، وإذا كانت ثمة حاجة لتشخيص الواقع وغربلة ما هو مطروح من مشاكل، وترتيبها حسب الأولوية، وتصور الحلول المناسبة لها، فليست المعارضة أحسن من يرجع إليه في هذا المجال، لأنها ببساطة ليست جهة اختصاص، وليس من دورها أصلا تقديم الاستشارة الفنية لنظام تدعي معارضته، بل أن دورها التقليدي هو النقد البناء وتبيين مكامن النقص والتقصير في تسيير ذلك النظام، والاستشارة الفنية إن دعت لها الضرورة فهي من اختصاص مكاتب الدراسات والخبراء التي تعج بهم مصالح الدولة، مع أن القائمين على تنفيذ برنامج الرئيس يفترض فيهم أن يكونوا أهل كفاءة وخبرة في مجال عملهم، وإلا فلا مبرر لاحتلالهم تلك الوظائف أصلا.
كثيرا ما تكون أجندات الحوار تتمحور حول مفاهيم عامة تصدح بها حناجر المرتزقة قبل أهل الصدق والسلامة إن وجدوا، من قبيل الوحدة الوطنية، العدالة والمساواة، الغبن الاجتماعي والإرث الإنساني، الديمقراطية، الانتخابات والتناوب السلمي على السلطة …. كل هذه المواضيع تم تناولها في حوارات سابقة، وبمشاركة نفس الأشخاص المطالبين بالحوار اليوم تقريبا، وعليه فلا فائدة ترجى منه ولا ضرورة تستدعيه، وبالتالي ينبغي العدول عنه، والدخول مباشرة في التطبيق الفعلي لما سيدعي منظموه أنه مخرجات له، حتى لا يضيع الوقت والجهد من أجل تحصيل حاصل.
عند ما يتم تطبيق العدالة بين المواطنين، جراء محاربة جدية للفساد، والمساواة أمام القانون والفرص بصفة عملية، والتوزيع العادل للثروة، من خلال الاستثمار في المشاريع التنموية العملاقة، في مجال الزراعية والصناعية والتنمية الحيوانية والبنى التحتية، سينتج عن ذلك خلق القيمة المضافة الضرورية للنمو والتنمية، وكذلك خلق فرص عمل كافية لامتصاص البطالة التي تنخر جسم المجتمع، فقرا وتخلفا وانحرافا، ولن يبق من المشاكل بعد ذلك إلا تحسينات قانونية قد تكون ناقصة في بعض المجالات، يمكن حينها طلب مقترحات من الفاعلين السياسيين دون اللجوء إلى تنظيم حوار، من أجل إشراك الجميع، لا لأي اعتبار آخر.
تاهت مصالح الوطن منذ زمن طويل في سراديب حسابات غير وطنية، ولن يتحقق أي شيء مما ذكر آنفا ما لم تتوفر الإرادة القوية الصادقة لدى القيادة الوطنية، وتجسيدها فعليا من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ومحاربة ومحاسبة المفسدين، ومحاربة الرشوة والمحاباة والمحسوبية والقبلية والطائفية … واعتماد معايير سليمة تسمح لأي شخص ذي كفاءة أن يتبوأ المكانة للائقة به، من هذه المعايير على سبيل المثال لا الحصر التخصص، الثقافة، التجربة، النزاهة والأخلاق، ولا بد من الوقوف سدا منيعا أمام المتاجرة بالقضايا الوطنية، والبحث لها عن حل جذري يقطع الطريق على أعداء الوطن داخليا وخارجيا، وينصف ذوي الحقوق ويساهم في تقوية اللحمة الاجتماعية، ويفتح آفاق تنمية تشاركية مستديمة، تستمد قوتها وديمومتها من قوة نفوذ وتنفيذ النظام الحاكم، وبدون إملاءات من بعض السياسيين الذين يتجاهرون بالوطنية ويتخذون من القضايا الوطنية مطية للوصول إلى أهدافهم الخاصة.